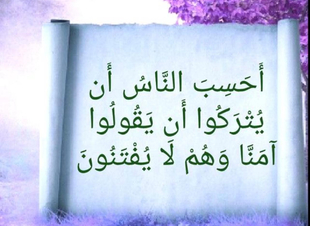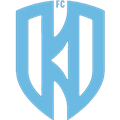الكاتب ـ عائض الأحمد
لم أكن يومًا من مُحبي البحر أو الإبحار أو الوقوف على شواطئ الزمن، وكانت الصحراء والرمال الملموسة المحسوسة حد الإحساس والتحسس، هي العشق والمهرب من أي شيء، كانت ملجأ واسعًا تمد النظر فيه فلا تجد سواك، وتجول ببصرك بعيدًا فتجدك تقف على كثبان أيامك وتكاد تقتلعك عاصفة أفكارك؛ فتحيطك رمال ذهبية تتراءى لك كنزا تُباهي به وتُراهن على قدرته في خلق نشوتك المستباحة في فضاء أرض لم تطأها قدم غير أقدامك، ولم ينعم بها عاشق ليُسكِنها بين جوانحه باحثًا عن دفء فقده.
تتمايز ذهابًا وعودة، تارة كمن يحمل المسك وأخرى كمن ينحر قربان يتشفى بإزهاق روحه غضبًا على أيام سعادته التي سُلبت منه عنوة، أو هكذا شعر في مهب ريح واعتلال أنفاس بين البؤس وترقب الفرج.
خيبة تؤرق من استشعر النجاح، وقسوة "مُلهمة" يحيطها صخب يعلوه استفهام وتسأل أو ليسوا صنيعة أفعالنا؟!
التأهب والمبالغة في السرديات، ليس عيبًا مُخلًا بأساطير وشخوص كل هذه الروايات؛ فهناك من لديه يقين بصدقها، وبعض أبطالها الحقيقيين ينعتون أنفسهم بالغفلة والزلل، وكأن كيف ولماذا تبدأ بحديثهم وتنتهي به أسفًا.
التسامح والعفو يفوقان قدرتك على تقبل "خيبات" الآخرين؛ فمقارنة غضبك بحلمك يفسره الحالمون بغفلة متصنِّع "كاذب" حاول أن يرشو السحاب، فأغرقه المطر وجرفته السيول وتقاذفته بطون الأودية، حتى نال منه القاصي والداني، وتبسمت منه مرابع الصحراء، وغدا كحصيرة أولئك المساكين الذين غشاهم الجوع فلم يجدوا غيرها ليفرشوه لينالوا حظًا من أحلامهم متناسين ما حل بهم من فاقة.
ختامًا.. صُحبة الأشقياء لا تخلو من ألم، ولن تنتهي دون ثمن، ويُقال إن الوفاء ليس ما تراه؛ بل ما تشعر به، فكم من سكينة في ضجيج يعلوها صمت صارخ.
شيء من ذاته: اللبن المسكوب نعمة زائلة، فماذا صنعت لتجلب المزيد منه لتسكبه؟ البكاء على الأطلال عجز ووهن ولو بلغت به قمم الجبال.
نقد: لم أعد أنتظر شيئًا منك فأنا في قمة الرضا والقناعة.


.jpg)


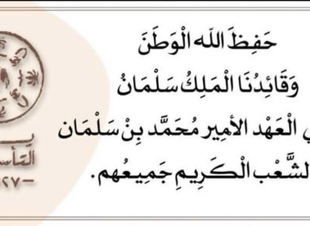


.jpg)
.jpg)

.jpg)